كل شيء بدأ عندما حولت طائرة روسية فوق المحيط الأطلسي مسارها، 24 مارس/آذار 1999. عندما كان ماكسيموفيتش بريماكوف، رئيس الوزراء الروسي في عهد الرئيس الأسبق بوريس يلتسن، متوجهاً إلى واشنطن لتحقيق هدف واحد ووحيد، هو تدارك الأزمة التي كانت على وشك الانفجار في كوسوفو. بينما كان الرجل منكباً على أوراقه ويدرس الاحتمالات، تلقى فجأةً اتصالاً من البيت الأبيض. كان يتحدث على الجانب الآخر نظيره الأمريكي، آل غور، يخبره بأن الولايات المتحدة وحلفاءها، على وشك قصف يوغوسلافيا.
الاقتصادي والصحافي الروسي السابق، أغلق سماعة الهاتف وطلب من قائد الطائرة الاستدارة والعودة سريعاً إلى موسكو، فقد كانت رسالة آل غور واضحة جداً لرئيس جهاز المخابرات السابق “كي.جي.بي”، أن للعالم الجديد زعيماً واحداً الآن، وأن أمريكا لا وقت لديها تضيعه في استشارة روسيا الفيدرالية، الوريث الجديد وقتها للاتحاد السوفيتي، ولو شكلياً بخصوص قصف “إخوتهم” السلاف – الأرثوذوكس الصربيين.
وفي 7 مايو/أيار 1999 وفي خضم حرب الحلفاء على القائد الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش، قصفت صواريخ أمريكية عابرة للقارات بـ “الخطأ” مبنى السفارة الصينية في بلغراد، ربما عقاباً لها على دورها في دعم ميلوسوفيتش استخبارياً. يُعتقد أن الصربي كان موجوداً في مقر قواته الملاصق لمبنى السفارة الصينية حينها. اعتذر الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، عن الخطأ الذي تسبب فيه استخدام الـ “سي.آي.إيه” لخرائط غير دقيقة، بحسبه. لكن الرسالة الأمريكية للرئيس الصيني، جيانغ زيمين، وقتها كانت واضحة، “الزم حدودك، ولا تحشر أنفك فيما هو ليس لك”.
في الوقت الذي قبلت فيه بكين هذه الإهانة، ووضعتها في الدرج ليوم تسترد فيه حقّها من واشنطن، انتظر الروس قرابة 15 عاماً يتربصون بالأمريكيين حتى يردوا لهم الصاع. لذا لم يسمح فلاديمير بوتين لصدمة الأيام الثورية الخمسة، التي طبخت على نار أمريكية ضد حليفه هناك، في العاصمة الأوكرانية كييف، العام 2014، أن تمر دون رد هذه المرة.
فبعد أيام قليلة في 18 مارس/آذار 2014 وخلال حفل تكريمي لذكرى سابق الذكر يفكيني بريماكوف ابن مدينة كييف، وصاحب فلسفة التعددية القطبية السياسية (روسيا- الصين- الهند)، أعلن الرئيس بوتين ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بعد ثورة أخرى هناك كانت قد طبخت هذه المرة على نار روسية. ويتقدم الرجل بالشكر الجزيل للصين التي بخلاف بقية دول العالم تقبّلت الحركة الروسية في القرم ورأتها، من وجهة النظر الروسية، استفتاء قانونياً تماماً على حق تقرير المصير، كما حصل في كوسوفو قبل أعوام قليلة. لكن هذا الشكر لم يكن فقط بسبب الموقف الصيني بالطبع، بل كذلك لدورها في إخراج روسيا من العزلة السياسية والاقتصادية التي فرضتها واشنطن وبروكسل على موسكو بعد ضم القرم.
تثير تساؤلات من حينها حول إمكانية أن تدفع الهيمنة الأمريكية الصين وروسيا لتشكيل حلف حقيقي لمواجهة الولايات المتحدة، رافقنا في هذا التقرير لنتعرف إلى إمكانية ذلك معاً.
“أمريكا من دفعنا للتقارب”
يمكن القول إن العلاقات بين روسيا والصين قد بدأت تتطور بشكل متواصل بداية منذ تسعينيات القرن الماضي، نتيجةً للتغير الذي طرأ على المشهد السياسي العالمي. إلى جانب ذلك، لم يكن هذا الميل للدفء في العلاقات بين الجارين العملاقين، غير المرضي عنه غربياً، إلا نتيجة طبيعية أخرى للتطورات التي طرأت على البلدين داخلياً، في سياق ارتدادات انهيار الاتحاد السوفيتي الدراماتيكي.
لذا وفي باكورة الألفية الجديدة، وضع البلدان حداً لخلافاتهما الحدودية، في سبيل أن يضعوا أساسات لتطور العلاقات الثنائية بشكل صحي يعود بالنفع على الطرفين. سياسة أبان عن تطوراتها السياسية العسكرية بين بكين وموسكو اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي وقَّعها زعيما البلدين، يونيو/حزيران 2019. بالنسبة لدولتين مثل روسيا ذات المساحة الأكبر في العالم والصين ذات عدد السكان الأكبر في العالم، من الطبيعي أن يشعرا بضرورة أن تكون هناك علاقات بينية مستقرة مبنية على الصداقة، خصوصاً وأنهما يتقاسمان آلاف الكيلومترات من الحدود.
منذ عقود تستمر الصين في استيراد الأسلحة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأخشاب، والبترول والغاز الطبيعي من موسكو، بينما يستورد الروس من الصين الأدوات الكهربائية، والملابس والأجهزة الإلكترونية. ومؤخراً، أطلق البلدان تعاوناً مشتركاً في قطاعات مختلفة أهمها مشروعات قطاع الطيران والفضاء.
لكن المصالح الاقتصادية المشتركة ليست فقط ما يزيد في دفء الغزل الروسي – الصيني المتبادل، بل إن موقف النظامين الحاكمين في بكين وموسكو المتشابه بخصوص المسائل العرقية الداخلية التي يواجهها كل بلد يقربهما أكثر. إذ أنهما يدعمان بعضهما بعضاً في هذه النقطة، فالموقف الروسي من قضية تايوان وإقليم شينجيانغ تثمنه بكين كثيراً، كما ثمنت موسكو كثيراً دعم بكين في مسألتي الشيشان وشبه جزيرة القرم. يتوج كل هذا التعاون الوثيق بينهما المعارك في مكاتب وجلسات الأمم المتحدة التي غالباً ما يقاتلون فيها من خندق واحد، أو من اثنين متقاربين على الأقل.

لكن في متابعة هذا التقارب الروسي – الصيني لا بد من الأخذ بعين الاعتبار العامل الأمريكي المهم والحاسم في هذا الصدد، إذ إن كثيراً من المختصين في دراستهم لتطور هذه العلاقات ينظرون إليها من خلال ثلاثية دولية (أمريكية – روسية – صينية). تعتقد ميلندا ليو، رئيسة مكتب صحيفة “نيوزويك” في بكين، أن التقارب في العلاقات بين روسيا والصين منذ 1991 قد صُهرت في بوتقة سياسات الاستعداء و “الضغط الإستراتيجي” الذي مارسه الغرب بحق الاثنين، وتذهب مؤلفة كتاب “ربيع بكين” للحد الذي تقول فيه إن السياسات التي مارستها الإدارات الأمريكية لاحتواء هاتين الدولتين دفعتهما للتقارب أكثر وبسرعة أكبر.
لم يكن لدى بوريس يلتسن، أول رئيس لروسيا الاتحادية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي العام 1991، أية مشكلة مع نظرة المعسكر الغربي إلى ما حدث في بلاده بانتصار الليبرالية الغربية على الاشتراكية السوفيتية؛ فالرجل أساساً، في العام 1987 عندما كان عضواً في المكتب السياسي السوفيتي، كان قد قدَّم استقالة بخطاب احتجاجي ولم يحدث أن استقال أحد من المكتب السياسي من قبل، فالرجل جاء إلى الحكم بعد أن بنى لنفسه صورة المتمرد والمناهض للمؤسسة السوفيتية، بل وعد الناس بكلمات حول نعيم الانفتاح الاقتصادي، فقد تعهد بتحويل الاقتصاد الاشتراكي الروسي إلى اقتصاد سوق رأسمالي وتحرير الأسعار والخصخصة. بكلمة أخرى، لم يكن لدى الروس مشكلة في معانقة الروح الليبرالية الغربية والاندماج بها مقابل ثمار اقتصاد الليبرالية الغربية، إن وجدت.
الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين نفسه، كان قد أبدى استعداداً كاملاً للتعاون مع واشنطن عند تسلمه السلطة العام 2000، فالرجل في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، أبدى تعاطفه مع ضحايا أحداث سبتمبر/أيلول 2001. وعرض مد يد العون للحملة الأمريكية في حربها في أفغانستان، وعمل على تسهيل وجود ممرات جوية خلال دول وسط أسيا، وشارك المعلومات الأكثر حساسية في الموضوع مع واشنطن مقابل غض الطرف عن الوضع في حرب الشيشان التي ترفض روسيا الاتحادية استقلالها.
إلا أن ذلك كله لم يقنع المعسكر الغربي بالانفتاح على الروس، ومحاولة بناء مستقبل جديد معهم، بدلاً من ذلك توسع الناتو على حساب أراضي حلف وارسو المنحل وصار أقرب مما لم يكن من الحدود الروسية، واشتعلت دول أوروبا الشرقية بـ “ثورات ملونة” في كل مكان. ومن ثم كانت العقوبات الاقتصادية الخانقة التي فرضت على موسكو، العام 2014، بعد ضم شبه جزيرة القرم القطرة التي سدت ما كان موارباً من باب الأمل في تحسن العلاقات مستقبلاً.
على الجهة المقابلة، لو كنا نجوب الشوارع الصينية في ثمانينيات القرن الماضي ونتحدث مع الشباب هناك، فسنلمس حماستهم، بحسب “هوو إيجون”، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، للدراسة في الجامعات الأمريكية. ربما كانوا حدثونا عن أحلامهم في حصولهم على الإقامة الدائمة والعيش هناك، وعن سعيهم في تحقيق حلمهم الأمريكي الخاص بهم. من يدري، فقد كانت الصورة العامة للثقافة الأمريكية حسنة في المجتمع الصيني، لدرجة أن كثيراً من المحللين السياسيين المحسوبين على الثقافة السياسية الأمريكية في البلاد، كانوا يتبنون في قضايا إستراتيجية مهمة مواقف مراكز الدراسات الأمريكية بحذافيرها.
لكن الصورة اختلفت كثيراً كما يقول إيجون منذ أن جاء الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، العام 2017. فإدارته مارست ضغطاً شديداً على الاقتصاد الصيني بحيث تغيرت معه الصورة الأمريكية عند الصينيين؛ فواشنطن تصرفت مع الصين بوصفها منافساً اقتصادياً وسياسياً في بعض الحالات، وتصرفت معها بوصفها عدواً في مرات أخرى. وما معركة التضييق على الشركات الصينية، مثل “هواوي” و”Zte”، إلا مؤشراً على هذه السياسة؛ لذا، نتيجة لهذا الخلاف التجاري المرِّ مع واشنطن اضطرت بكين أن توقف استيراد المواد الغذائية من الولايات المتحدة، وتستبدل بها موسكو، هذا التحول أنعش قطاع الزراعة الروسي في وقت قياسي، فبحسب وزير التجارة الصيني فقد تجاوز حجم التبادل التجاري مع روسيا حاجز الـ 100 مليار دولار، العام 2019، كما أنه توقع أن يزيد هذا التبادل 30%، العام 2019، بهدف تجاوز حاجز الـ 200 مليار دولار من التبادل التجاري في الأعوام القليلة القادمة.
لذا فهذا الواقع في حجم التبادل التجاري الهائل مع الصين التي تعد الشريك التجاري الأول لموسكو، يمثل دعماً كبيراً ومن كل النواحي لروسيا الاتحادية، خصوصاً من الناحية الاقتصادية والمعنوية من بعد العقوبات الغربية عليها نتيجة لأزمة ضم القرم. هذا التبادل المصلحي بين بكين وموسكو هو ما يشجع الطرفين على المضي قدماً في تطوير العلاقات بينهما على النحو الذي نراه مؤخراً.
أعلن الرئيس الروسي في منتدى “فالداي”، أكتوبر/تشرين الأول 2019، والذي كان بعنوان “النظام العالمي: قواعد جديدة أم لعبة من دون قواعد؟” أن بلاده ستساعد بكين في تطوير نظام إنذار مبكر لرصد الصواريخ البالستية، وتبادل الخبرات في المجال العسكري. وهذا ما لم يكن لنا أن نتخيل حدوثه لولا الثقة المتنامية في السنوات الأخيرة بين الطرفين. لكن الطرفين كانا حريصين على ألا تزعج هذه الثقة والود المتبادل الآخرين؛ لذا، لم يفوت الزعيمان فرصة تأكيد أن هذا التقارب أو شبه التحالف ليس موجهاً ضد أي أحد بتاتاً.
“لسنا حلفاء لكنَّنا نرفض الهيمنة الأمريكية”
لاحظ هنري كيسنجر، مهندس العلاقات الصينية – الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي، أكثر من مرة أن واشنطن لا تتعامل مع بكين من خلال سياسة بعيدة النظر. فقد لاحظ في كتابه “عن الصين” أن الضغط المستمر الذي مارسته الولايات المتحدة على روسيا والصين ساهم في تقاربهما إلى حد كبير. ويبدو أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يتفق تماماً مع هذه الفكرة، فقد دعا الرجل مراراً زملاءه في دول الاتحاد الأوروبي للانفتاح على موسكو، وعدم التخلي عنها لمصلحة الصين، لأنه في حال جرى ذلك فالقارة الأوروبية ستجد نفسها في ورطة حقيقية عندما تقع بين مطرقة الولايات المتحدة، من جهة، وبين سندان العملاقين الصيني والروسي، من جهة أخرى.
لكن ورغم النمو في العلاقات بين موسكو وبكين خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، فإنها لا ترقى من وجهة نظر الصين إلى الأهمية التي تحظى بها علاقتها مع واشنطن؛ فالصين كانت تعد واشنطن تقليدياً الضامن الدولي للنظام العالمي القائم الذي نمت فيه قوتها واقتصادها وسياستها. جزء كبير من القفزة الاقتصادية الهائلة التي حققها العملاق الآسيوي، منذ العام 1980 حتى اليوم، يعود في جزء كبير منه إلى العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بين البلدين، وإلى التعايش والتكامل بينهما على الساحة الدولية؛ لذا، فإن هذه المصالح الاقتصادية المالية الهائلة المشتركة تضمن أن الوضع السياسي، رغم حالات الشد والجذب الظرفية، لن يصل أبداً إلى مرحلة الصراع المفتوح بين بكين وواشنطن.
لهذا السبب، حتى وإن تعاضدت بكين وموسكو في رفض الهيمنة الأمريكية وانتقاد دورها، كما حصل في فترة “الثورات الملونة” التي اجتاحت القارة الأوروبية، وخلال صيف العام 2019 أثناء الاحتجاجات التي واجهتها البلدان، فإن مواقف بكين السياسية تجاه واشنطن دائماً ما كانت لينة، بعكس موسكو التي لا توفر أية فرصة دولية أو محلية لتوجيه سهام النقد لسياسة البيت الأبيض. يمكن القول إن هذا الموقف يأتي تحت التأثير العميق لحجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، فبالرغم من كل التجاذب الإعلامي الحاصل بين بكين وواشنطن بسبب قضايا حساسة (تايوان، إقليم شينجيانغ، التجسس الصناعي، بحر الصين الشرقي واحتكار العملات) فإن الطرفين يواصلان توقيع المعاهدات والاتفاقات التجارية بينهما، على أمل ألا يتحول هذا الاعتماد المتبادل من كل طرف على الآخر إلى سلاح سياسي واقتصادي بيد أحدهما في وجه الآخر.
ربما لهذا السبب تحديداً، تقيم بكين جدياً اقتراحات الانفتاح ورفع مستويات التعاون والتبادل التجاري المقدمة من موسكو، في سبيل الحد من الهيمنة الأمريكية، وهو الهدف الذي يشترك كلاهما فيه. ربما كان الإعلان الروسي لتمرير تكنولوجيا دفاعية عسكرية متقدمة للصين يأتي في سياق الإيمان عند الجانبين بضرورة التحالف لمواجهة التفوق الأمريكي، تماماً كالفكرة التي مررها الروس لجيرانهم الجنوبيين بضرورة التفكير بطريقة ما للافتكاك من سيطرة الدولار في السوق العالمية. لكن هل يكفي كل هذا لإقامة تحالف صريح بين روسيا والصين؟
على الأغلب، ولعدة اعتبارات يتعلَّق أولها بروسيا الاتحادية نفسها، ربما لا. إذ إن التقارب أكثر مع الصين يعني أن على الروس أن يقبلوا دور الشريك الهامشي لبكين. موسكو التي تسوق نفسها قوة عالمية اليوم لن يقبل كبرياؤها بإهانة كهذه، ما يعني أنها ربما لن تسعى لهذا النوع من الشراكة؛ كونها تدرك أن الميزان الاقتصادي والديموغرافي يصب في مصلحة الصين، وكونها تدرك استحالة اللحاق بالصين في هذين المضمارين، على الأقل في الفترة الحالية.
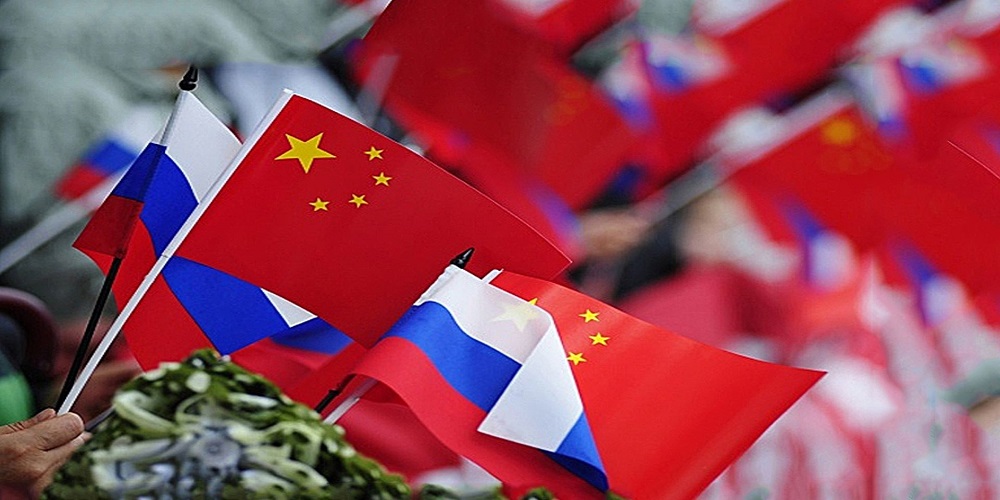
لذا ولتعويض نقطة الضعف هذه يسعى الروس لتعديل الميزان مع بكين من خلال التطوير الدائم لقوتهم العسكرية حتى في الجزء الآسيوي من أراضيهم الحدودية مع بكين، ومن خلال تكثيف العمل الدبلوماسي على المستوى العالمي الذي يبرع فيه الروس أكثر من نظرائهم في الصين، وأخيراً من خلال تحسين العلاقات مع القوى الإقليمية المحيطة بالصين مثل الهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وحتى فيتنام وسنغافورة.
منطقة آسيا الوسطى، التي يمكن عدها ملعباً خلفياً مشتركاً للطرفين سوف يتنازعان حوله عاجلاً أم آجلاً، تشكل نقطة تماس أخرى غير مريحة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين مع جيرانهم أبناء المدرسة السوفيتية في روسيا. ما لم يجد الإستراتيجيون من كل طرف من الحلول ما يقرب هذا التحالف المنشود والمستحيل في آن واحد. صينياً، تقع المنطقة في قلب مشروعها الساعي لإعادة إحياء “طريق الحرير” القديم، من خلال مشروع “الحزام والطريق”.
روسياً، تؤثر موسكو إستراتيجياً في المنطقة من خلال الاتحاد الأورو – آسيوي الاقتصادي. منظمة تحاول موسكو من خلالها خلق سوق اقتصادية بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة يكون مرتبطاً بها. مع حقيقة أن هذا المشروع الروسي يفتقر للدعم المادي أولاً، ولوجود البنى التحتية ثانياً حتى يرى النور. وهما العنصران اللذان يصدف أن يقوم عليهما المشروع الصيني في خلق شبكة هائلة من البنى التحتية، فالصين مستعدة للإنفاق عليه قرابة 160 مليار دولار في أكثر من 165 دولة تمتد على ثلاث قارات.
الفكرة مغرية للجميع، موسكو ستعمل على ضمان أمن الأسواق ولو عسكرياً إذا تطلب الأمر، مقابل هذه الانفراجة الاقتصادية العظمى، والصين ستكون سعيدة بإنجاز جزء مهم ومحوري من مشروعها في طريقه نحو أوروبا والشرق المتوسط وإفريقيا. لكن مع من ستتحدث بكين؟ هل ستتوجه لموسكو التي وإن صمتت على ضم القرم، وإبخازيا وأنغوشيا، فإنها لم تعترف رسمياً بضمها لها؟ أم تتوجه مباشرة لهذه الدول كونها حريصة على عدم إثارة الرأي العالمي؟ خصوصاً في ظل الانتقادات القائمة أصلاً حول المشروع وأغراضه.
في الوقت نفسه الذي لم تفرض أو تشارك الصين فيه بأية عقوبات على روسيا أسوة بالمجتمع الدولي، لم تعترف رسمياً بضم القرم خلال استفتاء العام 2014، بل لدى بكين علاقات سياسية واقتصادية جيدة مع أوكرانيا. في الواقع حتى موسكو ليست متضامنة مع الصين في كل قضاياها. كانت بكين تتوقع موقفاً من موسكو أكثر صرامة بخصوص نزاعها الحقوقي في البحر الصيني الشرقي، لكن موسكو آثرت موقفاً مبهماً حتى لا توتر علاقاتها مع الأطراف الأخرى في القضية، والتي تهمها مصالحها معها.
على كل، لم قد تتضامن موسكو مع من تحوم الشكوك حول نواياه في التسعينيات من القرن الماضي حول التوسع البشري والاقتصادي في الشرق الأقصى من أراضيها وفي فلاديفوستوك. لكن ورغم كل هذه التعقيدات يبقى النموذج الذي يحكم علاقة الطرفين حيث “يتعاونان أينما أمكن ويتنافسان أينما أمكن” قابلاً للنجاح والتطوير مع الوقت بحيث تتحقق مصالح كل طرف بعيداً عن الهيمنة الأمريكية، ودون تحديها على الأقل في الوقت الراهن.
المظاهر خداعة.. وهم التحالف بين روسيا والصين
يعتقد جورج فريدمان، المحلل الإستراتيجي في موقع “جيوبوليتيكال فيوتشر”، أن مجرد التفكير في أن هناك احتمالية منطقية للتحالف الروسي – الصيني بسبب الخصم المشترك للطرفين هو مجرد وهم غير قابل للتحقق؛ وذلك لأن الطرفين يعجزان حتى الآن عن حل مشكلاتهما العالقة ذات الطبيعة الاقتصادية والإستراتيجية، ما يبقي هذا التحالف ممكناً فقط نظرياً وعلى الورق. ظاهرياً يجمع الدولتين ويوحدهما الولايات المتحدة بوصفها خصماً مشتركاً، ما يؤهل لخلق أرضية قوية للتحالف على أساسها. فهما قوتان عسكريتان معتبرتان على الساحة الدولية، ويمكنهما اقتصادياً مساندة بعضهما بعضاً.
تعاني موسكو وبكين من مشكلات تتعلق باقتصاد كل منهما فاقمتها سياسات الولايات المتحدة بحق كل منهما. تأتي مشكلات روسيا بالأساس من مشكلة أسعار النفط العالمية التي لا تتوقف عن الانخفاض، وفي أحسن حالاتها لا تتوقف أسعارها عن التذبذب. وتتضخم المشكلة الروسية من حقيقة أن اقتصاد موسكو الذي يعتمد أساساً على تصدير النفط والغاز يرزح تحت وطأة العقوبات الأمريكية – الأوروبية، منذ العام 2014، في الوقت ذاته تكمن مشكلة الصين الاقتصادية في اعتمادها على قطاع التصدير بشكل كبير. واشنطن، التي تعد المستورد الأكبر للمنتجات الصينية، كانت العام 2019 قد فرضت تعريفة مرتفعة على ما حجمه 250 مليار دولار من الصادرات الصينية لواشنطن.
يبدو أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين لن يساعد في حل هذه المشكلة جذرياً، إذ تحتاج روسيا إلى بيع المواد الخام من النفط والغاز بكميات كبيرة جداً حتى تبقي اقتصادها على قيد الحياة، خصوصاً أنهما معاً يشكلان تقريباً 60% من مجموع صادرات روسيا الاتحادية ويسهمان بـ 30% – 40% من دخلها السنوي.
اشترت الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الروسي، ما نسبته 22% من الإنتاج النفطي وفقط 1% من إنتاج الغاز الروسي في العام الذي سبق أزمة “كورونا”. ومع حقيقة أن الصين، بحسب تقارير صحفية، قد احتلت المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مستورد للنفط والغاز، فإنها لا تستطيع الحصول على كمية أكبر من الجار الروسي بسبب فقر البنية التحتية بين البلدين لنقل النفط والغاز وتكريرهما وتخزينهما. لذا، فالصين يمكنها أن تساهم بتلبية جزء بسيط من احتياجات موسكو بإيجاد مشترين لإنتاجها، لكنها لا تستطيع شراء كميات كبيرة تمكن الأسعار من البقاء مرتفعة حتى تساعد روسيا اقتصادياً، هذا من جهة.
من جهة أخرى، تحتاج الصين كذلك إلى إيجاد مشترين لمنتجاتها. في العام 2017، شكلت الصادرات الصينية 20% من الناتج الإجمالي المحلي بحسب البنك الدولي، وتشكل الولايات المتحدة السوق الكبرى على الإطلاق للمنتجات الصينية إذ تستوعب واشنطن 19% من إجمالي صادرات بكين، بحسب مركز التجارة الدولية، وفي ظل حرب الضرائب الأمريكية على منتجات الصين، سعى الحزب الصيني الحاكم جاهداً لإيجاد مشترين بدلاء. روسيا؟ لا، لا تستطيع أن تكون البديل، وحتى إن أرادت فهي لم تستورد أكثر من 2% من إجمالي الصادرات الصينية العام 2017 الذي استوردت فيه واشنطن أضعاف أضعاف هذا الرقم.
عسكرياً، تبدو الأمور أكثر إيجابية، فالعلاقات الثنائية في هذا المضمار في تحسن مستمر خلال العقود الأخيرة. إذ تأتي الصين على رأس قائمة مستوردي الأسلحة الروسية، وبحسب مصادر إعلامية روسية اشترت بكين، العام 2019، منظومة “إس – 400” الدفاعية الروسية. وقد شاركت الآلاف من القوات الصينية في المناورات العسكرية الروسية الأضخم منذ انتهاء الحرب الباردة، سبتمبر/ايلول 2018. هذا التقارب قد أوحى للكثيرين بإمكانية أن يؤسس لتحالف مهم بين القوتين. لكنهم تغافلوا عن حقيقة أن التحالفات تقوم على أساس المصالح المشتركة، وأن بين البلدين تاريخاً طويلاً من عدم الثقة المتبادلة بسبب النزاعات المتكررة طوال السنين الفائتة على مسألة الحدود، وبسبب التنافس الشرس على آسيا الوسطى خلال فترة الحرب الباردة.
حالياً، إن الأولويات الإستراتيجية لكل منهما متخلفة تماماً. فروسيا التي تواجه ما تعده ضغطاً غربياً مستمراً عليها عند حدودها الغربية مع القارة الأوروبية، وبدرجة أقل في الشرق الأوسط، لا تستطيع إقناع بكين بالاستثمار على هاتين الجبهتين بسبب طول خطوط الدعم اللوجستي لقواتها هناك، ولتكلفتهما العالية من وجهة نظر بكين خصوصاً وأن أولويتها الإستراتيجية حالياً هي التفرغ لمضايقات واشنطن الجيو – سياسية في بحرها الجنوبي.
على الجانب الآخر، كم كانت تود بكين أن تلقى مساعدة بحرية من موسكو هناك انطلاقاً من قاعدتها البحرية في فلاديفوستوك، لكن الروس في الواقع لا يستطيعون خدمة الأثرياء الصينيين كثيراً في هذا الملف بسبب وقوع اليابان على طريق الإنقاذ، وبسبب وجود قواعد قوات جوية أمريكية في المنطقة تحول دون ذلك. وفي حال أي اشتباك عسكري هناك، فما أسهل أن تتحول فلاديفوستوك إلى فخ للسفن الروسية لا يمكنها الخروج منه.
المصدر: ساسة بوست.
مصدر الصور: نداء الوطن – العربي الجديد – الميادين.
موضوع ذا صلة: الصين تعرض السلام.. هل تستجيب واشنطن؟

مأمون خلف
باحث فلسطيني – إيطالي.





