أين يقع العالمين العربي والإسلامي وسط التحوّلات الهائلة في النظام العالمي، وإلى أيّ مدى يمكن لعالمنا أن يجد له موقعاً في النظام المقبل في ظلّ الصّراع المحتدم على النفوذ بين القوى الكبرى.
هذا الحوار مع الباحث في الفكر السياسي الأكاديمي اللبناني الدكتور علوان أمين الدين، مؤسس مدير “مركز سيتا” – لبنان، يضيء على مجموعة من المعايير التي تحكم هذا الاحتدام، ولا سيّما على منطقتنا بصفةٍ خاصةٍ.
“المحرّر”
* على ضوء بحوثكم في حقل الجيوبولتيك والجيوستراتيجيا.. كيف تبدو لكم صورة النظام العالمي اليوم؟ وما هو أثر الموقعيّة الجيو – ستراتيجية للعالم العربي والإسلامي في إعادة تشكيل عالمٍ ممتلئٍ بالفوضى وعدم اليقين؟
– عند النّظر إلى طبيعة النسق الدولي، أو ما يُعرف بالنّظام العالمي، يمكن القول إنّنا نعيش في عالم “اللا قطبيّة” بشكلٍ كبيرٍ بعد أن كان العالم محكوماً بقطبٍ آحاديٍّ، ألا وهو الولايات المتحدة الأميركية عقب تفكّك الإتحاد السوفياتي أوائل تسعينيات القرن الماضي؛ حيث لم تعد دولة كبرى واحدة قادرة على فرض سياساتها بشكلٍ كاملٍ لكونها ستصطدم بغيرها.
في ذاك الوقت، حدث أمر مهم جداً غالباً ما يتناساه العديد من الخبراء، وهو قيام منظّمة التجارة العالميّة، 1 يناير/كانون الثاني 1995، التي شكّلت أداةً أميركيّةً جديدةً، مع كلّ من البنك الدولي وصندوق النقد، من أجل فرض نفوذها وهيمنتها الاقتصاديّة على العالم بجانب قوّتها العسكريّة.
هذا التفرّد الأميركي، أطلق العنان للحروب بشكلٍ كبيرٍ، من حرب الخليج الثانية أي “عاصفة الصحراء”، مروراً بحرب يوغسلافيا وتقسيمها، وصولاً إلى حربي أفغانستان، 2001، والعراق، 2003. هذه الأحداث وقعت في ظلّ تفوّقٍ أميركيٍّ غربيٍّ وضُعفٍ شرقيٍّ، أو مقابل؛ حيث كان الاتحاد الروسي يعاني العديد من الأزمات بسبب سياسات الرئيس الراحل بوريس يلتسن، في حين كانت الصين تعمل جاهدةً بصمتٍ حثيثٍ من أجل أن تكون عملاقاً اقتصادياً.
هذا التفوّق الأميركي كان له تداعياتٌ سلبيّةٌ؛ حيث إنّ واشنطن لم تستطع أن تحصل على كلّ ما تريده من هذه الحروب مالياً؛ فهي لم تحصل على نفط العراق بالشكل الذي تريده، ووقعت في وحول افغانستان، كما حصل مع الاتحاد السوفياتي، وغيرها من الأمور. بالتالي، ضربت في العامين 2007 – 2008 واشنطن أزمةً ماليّةً كبيرةً أصابت العديد من القطاعات بالإفلاس والشلل. في هذا الوقت، كان “الدب الروسي” يلملم أوراقه في الشيشان وجورجيا، ويفرض نفسه لاعباً على الساحة الدّوليّة بعد الإصلاحات التي أجراها في الداخل، كما أصبحت بكين “مصنع العالم” وأغرقت الأسواق بمنتجاتها.
بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي، يبدو بأنّه من الصعب جداً أن يكونا عاملاً أساسياً في تشكيل إيّ نظامٍ دوليٍّ جديدٍ، خصوصاً في ظلّ التفكّك والتشرذم الذي يعيشانه اليوم، مع العلم أنّهما يمتلكان قوّة كبيرة يمكنها، ليس فقط التأثير على أيّ نظامٍ عالميٍّ مستقبليٍّ، لا بل المشاركة في تشكيله وفرض ما يناسبهما على قواعده، لا سيما دول العالم الإسلامي، الذي يعدّ أكبر من العربي، التي تمتدّ من جاكرتا، في أندونيسيا، إلي طنجة، في المغرب، وربما أبعد من ذلك أيضاً. كلّ ذلك ينبع من إمتداده الجغرافي وإشرافه على العديد من المناطق الحيويّة: مضائق وثروات طبيعيّة وغيرها الكثير الكثير. هذا العامل الجيو-بوليتيكي يعطيه القدرة اللّازمة، لا بل الكافية من أجل أن يكون عنصراً فاعلاً في أيّة تسويات أو تطوّرات مستقبليّة. بالتالي، يجب إعادة اللّحمة إلى المنظّمات الإسلاميّة والعربيّة من خلال وضع مخطّطاتٍ مشتركةٍ نهضويّةٍ تساهم في إحياء دورها من جديد. ما المانع من إقامة مشروع إقتصادي – سياسي – تنموي، على غرار “طريق الحرير” الصيني، خصوصاً مع توافر الإمكانات الماليّة والبشريّة واللوجستيّة؟
هذه الدول اليوم بحاجة إلى قرارٍ سياسيٍّ موحّدٍ من أجل أن تضمن مستقبلاً لها، وإلّا ستقع فريسة الواحدة تلو الأخرى؛ بحيث لن تكون سوى بيدقٍ من بيادق رقعة الشطرنج الدوليّة، يحرّكها مستخدموها عند الحاجة، وقد يضحّون بها خدمة لمصالحهم.
* يشهد الفكر السياسي المعاصر جدلاً عميقاً حول ما يُسمى بنظريّة «ما بعد الاستعمار»، وهذه النظريّة – كما هو معروف- بالقدر الذي تنطوي فيه على نقدٍ للتجربة الاستعماريّة، فإنّها في الوقت نفسه تُعيد إنتاج الفكر الاستعماري بوسائلَ شتّى.. كيف تقاربون هذه النّظريّة وما هي الأسس التي تستند إليها؟
– من المعروف جليّاً أنّ السياسة تقوم على المصالح لا على المشاعر والعواطف، حتى لو تعلّق الأمر بتقديم مساعدات إنسانيّة خلال الكوارث أو الأزمات. حتى تلك المساعدات تبقى رهينة أجنداتٍ سياسيّةٍ مصلحيّةٍ لدى الدول المانحة. برأيي، الاستعمار هو الاستعمار سابقاً ولاحقاً، لكن أسلوبه وشكله قد يتغيّران خصوصاً أنّنا نعيش اليوم في عالمٍ محكومٍ بـ “الذكاء الاصطناعي”، وهو ما نراه من خلال تطوّر الفكر البشري وتوسّع المفاهيم لدى الشعوب؛ بحيث إنّها باتت تفكّر أكثر في الحجج التي تقدّمها دولها أو الدول الأخرى من أجل شنّ الحروب أو العمليات العسكريّة، كما هو الحال في غزو العراق العام 2003 على سبيل المثال.
من هنا، بات للاستعمار أدوات دوليّة مهمّتها “إغراق” الدول بالديون من أجل ابتزازها سياسيّاً، وهو ما نراه عمليّاً في الكثير من الدول. وليس سرّاً بأنّ الكاتب الأميركي، جون بيركنز، قد فضح ذلك ضمن كتاب أصدره بعنوان “اعترافات قاتل اقتصادي”، دوَّن فيه خبرته وتجربته في إفلاس العديد من دول أميركا اللاتينيّة، وكيف تم استخدام هذه المؤسّسات كـ «سلاح مالي» من أجل الضغط على الدول والحكومات، لا بل وصل الأمر إلى حد اغتيال رؤساء دول مثل عمليّة اغتيال عمر توريخوس، الحاكم الفعلي لبنما في عام 1981 بسبب معارضته للسياسات الأميركيّة في بلاده، خصوصاً وأنّ لواشنطن مصلحةً حيويّةً في ذاك البلد، والمتمثّلة في قناة بنما.
ومن هذه الأدوات أيضاً، حكام الكثير من الدول الذين يُوالون الغرب وينفّذون أجندته، بشكلٍ مباشرٍ أم غير مباشر، من خلال سياساتهم التي تتسم بالفساد والهدر المالي، ما يستتبع جعل الدولة مدينة للأدوات النقديّة الدوليّة، وهو ما يُسهّل عمليّة ابتزازها وبيع أصولها، لا بل حتى تفليسها إذا اقتضى الأمر، فتصبح رهينة سياسات الغرب وإملاءاته.
وفي مثلٍ واضح، لا يزال صراع شمال – جنوب قائماً حتى الآن، فالشمال الغني يريد استعمار الجنوب الفقير والاستلاء على موارده وتصريف إنتاجه فيه. هذا الأمر نراه بوضوح ضمن سياسة أوروبا القديمة – الجديدة تجاه أفريقيا؛ حيث تفبرك الانقلابات ويتمّ السيطرة على الموارد وتهدّد الحكومات والدول. كلّ ذلك هدفه الوصول إلى مواد هذه “القارة العذراء” والتي تكتنز الخيرات الكبرى.
أبرز دليل على ما سبق وقلناه هو المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول الأوروبية من أجل الشراكة مع دول القارة السمراء. على سبيل المثال، بعد تأكيد خروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي، قام رئيس الوزراء بوريس جونسون بعقد مؤتمر في لندن حضره العديد من زعماء القارة، وكذلك الأمرمع ألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي كانت تقتسم دول القارة، بحسب ما رسخته قواعد “مؤتمر برلين” 1884 – 1885 الذي قسّم دول أفريقيا كمستعمراتٍ أوروبيّةٍ.
اليوم، نرى صعوداً صينيّاً لافتاً ومخالفاً لما تمّ التعارف عليه سابقاً من تدخّلٍ في شؤون الدول بحجّة الاستثمار، خصوصاً ما عرف بمبادرة “حزام واحد .. طريق واحد” التي تربط دول العالم عبر شبكةٍ اقتصاديّةٍ كبرى أهمّها تسهيل طرق المواصلات والتجارة الدوليّة. بالنسبة إلى بكين، هي تعتمد على أسلوب “التمدّد الرخو”، أي البطيء وغير المزعج؛ حيث إنّها تقوم بمشاريع تنميةٍ في مقابل استثماراتها على قاعدة رابح – رابح، بحسب وجهة نظرها.
ما تقوله بكين بأنّ هذا “الحلم الصيني” هدفه ربط العالم عبر التجارة. لكن يبقى الخوف عند العديد من الدول، لا سيما الكبرى منها، بأن يكون هذا المشروع هو مقدّمة للسيطرة عليها من باب التعاون والاقتصاد، بالرغم من محاولات الصين المتكرّرة تبديد هذا الهاجس، خصوصاً وأنّ نزعة السيطرة متجسّدة في ذاكرة الدول وسلوكياتها، وهي دائماً ما تسعى إليها في كلّ وقت متحيّنة الفرصة المناسبة لذلك.

* أين أصبحت مركزيّة الغرب الآن، في ظلّ التحوّلات الكبرى التي تشير إلى تشكّل عالمٍ متعدّد الأقطاب، وهل ثمّة إمكانيّة واقعيّة لقيام مثل هذا النظام المتكافئ في العلاقات الدوليّة؟
– بدأت معالم التحوّل الاستراتيجي الغربي، في أواخر العام 2010، عندما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلري كلنتون، بأنّ القرن الـ 21 هو “القرن الباسيفيكي”. من هنا، نرى بأنّ الولايات المتحدة قد بدأت بالتركيز على وقف صعود “التنين الأصفر” اقتصادياً خوفاً من تربّعه على عرش الاقتصاد العالمي، وهذا ما قد يستتبع تحوّلاً ما في سياسات الدول للحاق بركبه والتخلي رويداً رويداً عن تبعيتها لواشنطن.
من هنا، نرى كيف “شيْطَن” الرئيس الأميركي السابق -دونالد ترامب- الصين حيث بدأ الحرب التجاريّة عليها منذ تولّيه لمقاليد السلطة في البلاد، ناهيك عن الحملة الدعائيّة الكبرى على خلفيّة موضوع انترنت “الجيل الخامس – G5″، والتي يرى الكثير من الخبراء في هذا المجال بأنّها ستحقّق نقلةً نوعيّةً للصين على الصعيد التكنولوجي.
في هذا الشأن، يوجد مسألة مهمّة أيضاً، وهي الخروج الأميركي من أفريقيا. وهنا، لا نعني الخروج النهائي بل إعادة التموضع وسحب الكثير من القوات والعناصر المتواجدة هناك ونقلها إلى خطوط المواجهة مع الصين. تعلم الولايات المتحدة جيداً بأنّ القارة الأفريقيّة مهمّة جداً بالنسبة إلى أوروبا، في العديد من المسائل. بالتالي، إنّ سحب هذه القوات سيزيد من الضغط على دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا من جهة، وسيؤمّن المصالح الأميركية بطريقةٍ غير مباشرةٍ عبر تلك الدول كونها لا تزال تحت مظلّة حلف شمال الأطلسي – الناتو. سنكتفي بهذا القدر؛ لأنّ الموضوع يطول.
بناء على ما سبق، تسعى واشنطن إلى تقويض الصعود الصيني، ما يعني الإبقاء على نظم الآحاديّة القطبيّة، وسيطرة الولايات المتحدة على مفاصل السياسة الدوليّة. على سبيل المثال، إنّ الاستثمارات الصينيّة المترافقة مع نوعٍ من التنمية سيجعل الحكومات والدول تطالب بإدخال الشركات الصينيّة إلى الأسواق المحليّة خصوصاً وأنّ بكين هي عنصر مقبول في أغلب دول العالم، بما فيها تلك الموالية لواشنطن.
هذا الدخول، سينعكس على قدرة الولايات المتّحدة في التأثير والضغط على الدول بما في ذلك سلاح المؤسّسات الماليّة العالميّة، كالبنك الدولي الذي تتمتع فيه وحدها بحق النقض. فلقد أنشأت الصين البنك الآسيوي للاشتثمار في البنى التحتيّة – AIIB حيث شاركت العديد من دول أوروبا في تأسيسه على الرغم من الضغوط القويّة التي مارستها الولايات المتّحدة عليها، لا سيما تلك على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. برأيي، ليس لهذا البنك تأثير كبير على الساحة الدوليّة الآن، لكن ليس هناك ما يمنع من أن يكون أداةً ماليّةً مستقبليّةً بوجه المؤسّسات التي تُسيطر عليها واشنطن، هذا إذا ما أضفنا معه بنك دول البريكس التي حاولت الولايات المتحدة، ونجحت، في تجميد دور برازيليا في هذه الرابطة الاقتصادية العالمية، عقب انتخاب “ترامب البرازيل”، جايرو بولسونارو، رئيساً لها.
وفي موضوعٍ مترابطٍ، يمكن وضع الاضطرابات التي ضربت فنزويلا ومحاولات اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو والاعتراف برئيس البرلمان خوان غوايدو كلّها في سلّة الإمساك بالنظام العالمي. برأيي، إنّ سبب تغيّر الحالة الأميركية مع كاراكاس من الاحتواء إلى الانقلاب سببه الرئيس هو وصول القاذفات الاستراتيجية الروسيّة إليها، وذلك ضمن مناوراتٍ مشتركةٍ، مطلع العام 2019. هذا الأمر، شكّل رسالةً واضحةً لواشنطن بأنّ “حديقتها الخلفيّة” باتت قابلة للاختراق، ومن الناحية العسكرية بالتحديد، وهو ما يهدّد أمنها القومي في الصميم، وهو ما يُذكّرها أيضاً بأزمة الصواريخ الكوبيّة، العام 1962، والتي لا تريد استعادتها من جديد.
أضف إلى ذلك مسألة إرسال إيران لسفنٍ محمّلةٍ بالبنزين إلى كاراكاس في تحدٍّ كبيرٍ للإدارة الأميركيّة، حيث هدّدت طهران بأنّ إيّ استهداف، أيّاً كان، لسفنها سيتمّ الرّدّ عليه وبشكلٍ قاسٍ. نقول كلّ ذلك لنصل إلى خلاصةٍ بسيطةٍ مُفادها بأنّ النّظام العالمي الجديد بدأت ملامحه البسيطة بالتّشكّل، ولكن من الصّعب جداً أن يتحوّل بسرعة، كما يظنّ البعض؛ إذ لا تزال لدى الولايات المتحدة أوراق قوّة كبيرة لا يُستهان بها، وخصوصاً داتا المعلومات عبر شبكات وبرامج التواصل، والتي تعدّ أحد أهمّ الأسلحة في يدها، ناهيك عن قوّتها التكنولوجيّة العسكريّة، والدولار، وتحكّمه بمفاصل التجارة العالميّة، والتي تستطيع عبره واشنطن فرض العقوبات وشلّ أو تعطيل الاقتصادات المنافسة.
إنّ نظاماً متعدّد الأقطاب لا شكّ بأن يكون عاملاً مهمّاً لتوازن العلاقات الدوليّة؛ بحيث لن تخاف الدول الوسطى والضعيفة من سيف القوّة الآحادية؛ إذ يمكنها أن تسيّر أمورها عبر “الابتزاز” السياسي للأقطاب، أي بأن يكون لديها سلاح قويّ تهدّد به، ولو كانت قدراتها ضعيفة، وهو الانتقال من محور إلى آخر؛ بالتالي، ستجبر الراعي الدولي لها بتحقيق متطلّباتها؛ كي تبقى تدور في فلكه السياسي.
* شهد الربع الأخير من القرن العشرين والعقدان الأوّلان من القرن الجاري تحوّلاتٍ جذريّةً في المفاهيم التي انبنى عليها الفكر السياسي، لا سيّما لجهة تحكّم الليبراليّة الجديدة بمصير العالم المعاصر وتحوّلاته. ما هي برأيكم الآثار التي ترتّبت على اتّجاهات التفكير في إدارة النّزاعات الدوليّة، وخصوصاً ما يتعلّق منها بمسارات الحرب والسلام؟
– لا شكّ بأنّ للأنظمة الاقتصادية الأثر الكبير على تحديد سياسات الدول، لا سيّما العظمى والكبرى منها. فهي ترى بأنّ هذا النظام الاقتصادي هو النظام الذي يُحقّق لها مصالحها، فتبدأ بتنفيذه ولو وصل الأمر إلى استخدام القوّة العسكريّة.
في عالم اليوم، بدأنا نعيش في واقع “آحادي اقتصادي” تسيطر عليه النّزعة الليبراليّة الجديدة، والتي يعتبرها الكثير من المراقبين والمتخصّصين بأنّها “أكثر وحشيّة” من النسخ السابقة. يأتي ذلك في وقتٍ يُسيطر فيه الدولار على الاقتصاد العالمي، ناهيك عن ربط العالم بالنّظام المصرفي الأميركي؛ حيث تستطيع واشنطن مراقبة حركة أي دولار في العالم عبر وول ستريت. هذا لوحده، يعطيها قوّةً فوقيّةً على بقيّة دول العالم.
من هنا، قد يكون الدولار هو سبب نزاعاتٍ حاليّةٍ ومستقبليّةٍ في العالم، كونه يشكّل سلاحاً مسلّطاً على رقاب الدول، لا سيما وأنّ القيمة السعريّة لأيّ سلعةٍ يتمّ تحديدها عبره، وأبرزها على الإطلاق موارد الطاقة، كالغاز أو النفط. كانت فكرة إنشاء “بنك البريكس”، الذي أشرنا إليه في ما سبق؛ ليكون بنكاً وطنيّاً ذا بُعدٍ عالميٍّ؛ إذ من المفترض أن تقوم الدول بتنفيذ التبادل التجاري المشترك عبر عملاتها الوطنيّة. أبرز مثال على ذلك ما ذكرته المعلومات من قيام الصين بتسديد قيمة الغاز، الذي سيصل إليها من روسيا عبر خط “قوة سيبيريا”، بالعملة الوطنيّة، أي اليوان. هذا الأمر، سيكون له آثار كبيرة بالطبع على قيمة الدولار وقوّته التي ستنقص إلى حد ما. في المقابل، لهذا الأمر الكثير من المحاذير وأبرزها أن بكين لا تريد أن تضعف قوّة الدولار خصوصاً وأنّها الدائن الأوّل للولايات المتحدة، وأيّ تغيير في العملة سيُؤثّر على ديونها، وأيضاً احتياطاتها من العملة الخضراء. لذلك قلنا بأنّ للولايات المتحدة أسلحةً كثيرةً في جعبتها لم تستخدمها كلّها بعد.
أمّا فيما يخصّ ما سبق وتأثيراته على النزاعات الدولية، فإنّني أرى بأنّ كثيراً ما يُسيطر الأقوى على مجريات تلك النزاعات، وأحياناً كثيرةً بعيداً عن القانون والقواعد والأعراف الدوليّة. وأبرز مثال على ذلك، ما حدث من تفرّد واشنطن في اتّخاذ ما يُناسبها من قراراتٍ، إلى حدّ الضّغط وابتزاز الأمم المتّحدة عبر التوقّف عن دفع اشتراكاتها، التي تعتبر العصب المالي الرئيس لهذه الهيئة الدوليّة.
مثلاً، عندما استلم المحافظون الجدد قيادة أميركا، ظهر حتمياً كيفيّة إدارة العالم من منطلق القوّة لا القانون. على سبيل الذكر، قال جون بولتون، أحد صقور المحافظين ومستشار الأمن القومي الأميركي السابق، في أوائل القرن الـ 21 عن الأمم المتحدة بما معناه “إنّ إزالة عشرة طوابق من مبناها في نيويورك، لن يغيّر من الأمر شيئاً، ولا من دورها في العالم، قليلاً أو كثيراً!” هذه العبارة كفيلة لنرى كيف أنّ القوّة هي أداة الفصل.
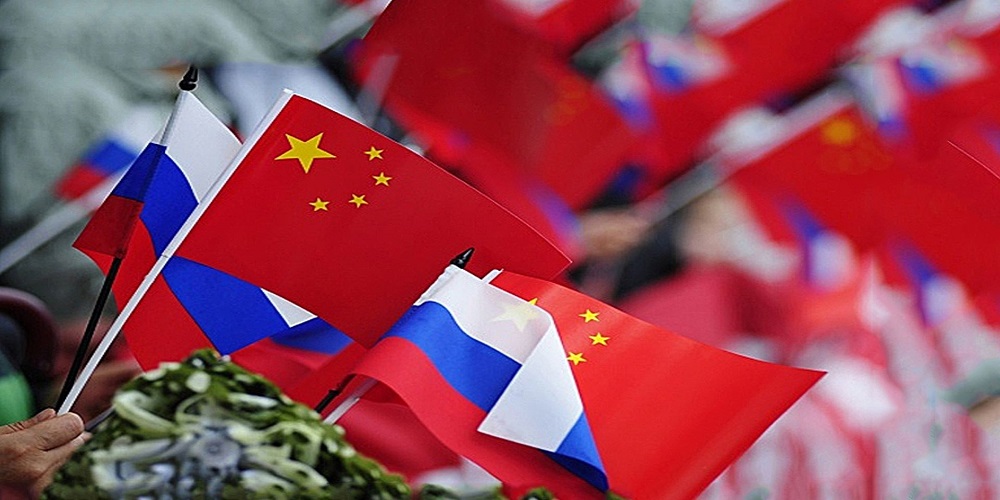
أما بالنسبة إلى الدول التي لا ترتقي إلى هذه المنزلة من القوّة بعد، فهي دائماً ما تتمسّك بالشرعيّة الدّوليّة، المتمثّلة في المؤسّسات الدوليّة، من أجل الإبقاء على حقوقها. ولكن في حال استعادتها للقوّة فإنّها، وبحسب اعتقادي، ستجنح إلى مصالحها على حساب الشرعيّة الدوليّة التي كانت تتطالب بها. إنّ نزعة السيطرة هي “موروث جيني” للعقليّة السياسيّة للدول، بحيث تسعى إلى الهيمنة وتحقيق مصالحها على حساب بقية الدول والشعوب سواء تطابق ذلك مع القانون الدولي أو لم يتطابق.
من هنا، إنّ وجود نظامٍ عالميٍّ متعدّد الأقطاب، وليس ثنائي القطبيّة كما كان حاصلاً ما بين العامين 1945 – 1991، سيكون أكثر أماناً من غيره من النّظم العالميّة في تحقيق نوع من الاستقرار؛ حيث قد يقف عدد من الأقطاب في وجه قطب آخر، وطبعاً بسبب اختلاف المصالح، من تحقيق شيء ما وهذا يعني تجنّب أزمة أو شبه أزمة. لكن المشكلة الكبرى تقع في حال توافقت هذه الأقطاب على المصالح نفسها. بالتالي، إنّ النتيجة ستكون كارثيّةً بالتأكيد وقد تفوق ما يمكن أن يحدث في عالم آحادي أو متعدّد الأقطاب.
* نال العالمان العربي والإسلامي قسطهما الأعظم من النتائج الكارثيّة المترتّبة على الفوضى الخلاقّة خلال العقدين المنصرمين. كيف تُقوّمون ما عرف بثورات “الربيع العربي” وما أفضت إليه من تداعيات إلى الآن؟
– بعد مرور أكثر من 9 سنوات على ما سمّي بـ “الربيع العربي”، وانكشاف المخططات من برنارد لويس ورالف بيتر، ودور التنظيمات الإرهابيّة وتبعيتها وأجندتها، يمكن القول بأنّ تلك الأحداث هي جزء من مخطّط غربيٍّ كبيرٍ؛ لضرب العديد من القوى في المنطقة، لا سيما عند النّظر إلى تفاصيل ما حدث من تونس إلى مصر وليبيا وسوريا وغيرها من الدول. إنّ هذا “الربيع” لم يأتِ إلّا على ما تبقّى من عصب القوّة في تلك الدول. فتلك التي لم تنهار، تضاءلت قدراتها وأصبحت رهينةً لمن يحميها وسياساته التي تنطلق من مصالح قوميّة.
أيضاً، حمل هذا المشروع معه موضوع قيام الدول القوميّة، وهنا نقصد القوميّة الدينيّة، خصوصاً في منطقة المشرق المجاورة لإسرائيل؛ حيث عملت العديد من الشخصيات والقوى المحليّة، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، على هذا الأمر؛ من أجل تحقيق حلم قديم – جديد. وكلنا يعلم بأنّ هذه الفكرة ستفتّت هذا المشرق لصالح إسرائيل التي تنادي بـ “يهودية الدولة”، مكرّسةً ذلك بدعوة الدول بنقل سفاراتها إلى القدس تمهيداً لإعلانها عاصمةً سياسيّةً بعد تكريسها كعاصمةٍ دينيّةٍ. فعندما تصبح محاطة بدول دينيّة، وبالطبع ضعيفة، سيكون لها الحجّة في الإعلان عن هويّة الدولة الدينيّة بشكلٍ طبيعيٍّ ومقبولٍ، وتستطيع من خلاله تخيير، إنْ لم يكن طرد، السكّان الأصليين بين الالتحاق بـ “دولهم” أو البقاء كـ “خدم” ضمنها.
في هذا الشأن، تبيّنت العديد من المواضيع عبر تلك الأحداث التي عصفت بالمنطقة منذ العام 2011، وباتت واضحة للكثيرين، بحيث يستطيعون معرفة خلفيات هذا المشروع من دون الغوص كثيراً في التحليلات.
* إلى أيّ مدى تستطيع النّخب في مجتمعاتنا صوغ استراتيجيات معرفيّة للمواجهة الحضارية مع الغرب في إطار مشروع التأسيس لعلم الإستغراب؟
– تزخر مجتمعاتنا بالكثير من الأدمغة والنّخب التي تستطيع سوغ استراتيجيات كبرى، والتاريخ خير شاهد على الأمر؛ حيث إنّ الحرف صُدِّر من مدينة جُبيل – لبنان إلى العالم أجمع، والسومريون علّموا الناس الحرث والزراعة، وعلماء الكيمياء والطب لا يزالون حتى اليوم محلّ تقدير واهتمام، وغيرهم الكثير الكثير.
من هنا، نحن لا ينقصنا شيء سوى الاهتمام بهذه العقول وتوفير الإمكانات كافّة لها، ما يعني عدم مغادرتها إلى الخارج والمعاناة مما يُعرف بـ “هجرة الأدمغة”. فلو توفّرت الإمكانات لدى الباحث في بلادنا، لمّا اضطرّ إلى المغادرة والعمل في الغرب تحديداً، الذي يؤمن له الكثير من وسائل الراحة الماليّة والمعيشيّة والبحثيّة.
برأيي، إنّ الإمكانات موجودة، ولكنّها ممنوعة في الوقت نفسه، وهي سياسة ممنهجة عن وعي وإرادة. إنّ ارتباط الغالبيّة العظمى من سياسيي ومسؤولي دولنا مع الغرب هو ما يُغذّي سياسة الهجرة تلك، والتي تؤدّي إلى استنزاف دولنا؛ بحيث يستفيد الغرب من عقولنا، ويستفيد سياسيونا من البقاء في الحكم، أي معادلة “رابح – رابح” ولكن على طريقتهم بالتأكيد.
المصدر: المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية.
مصدر الصور: أرشيف سيتا.
موضوع ذا صلة: قراءة في كتاب “الحرب الهادئة: مستقبل التنافس العالمي”





