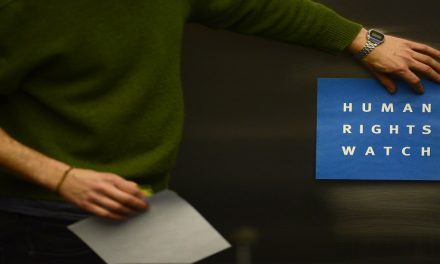كثيراً ما نسمع ونقرأ عن قيام حكومات بمحاكمة رموز الفساد في بلادها، وسوقهم إلى المحاكم بتهم فساد ترقى لأن تكون جرائم ضد الوطن أولاً وضد الشعوب ثانياً؛ هذا الأمر في عنوانه العام يتصدر وسائل الإعلام العربية، ويقول إن هذه البلاد حريصة على أوطانها حرصها على نفسها، ويسعدنا حقيقة إن صح ذلك، ولكن!!!
منذ سقوط الخلافة العثمانية، أي قبل قرون مضت وإلى يومنا هذا، لا نزال نسمع عن محاكمة رموز الفساد، خصوصاً من قبل الأنظمة الجديدة التي ورثت ملفات النظم السابقة، إن كان عبر الإنقلابات أو الثورات، أو حتى بوفاة الزعيم أو الرئيس، وتخرج علينا مفردات عن محاكمة النظام الديكتاتوري ورموزه، أو من قام بمجازر جماعية وإرتكب جرائم حرب، أو من سرق قوت شعبه، أو أو أو.. إلخ.
كل هذه العناوين يجب التوقف عندها، خصوصاً أننا قد خبرناها منذ نعومة أظافرنا. لكن السؤال الأهم: هل تعلمت الشعوب العربية الدرس؟
“سياسة القطيع”
لا نستطيع القول، ونحن في القرن الـ 21، أن الشعوب العربية تعلمت أي درس طالما هناك من يساق خلق شخص واحد، زعيم أو عالم دين، أو رئيس منصب ما، أو ما شابه ذلك. حتى اليوم، لا يزال التهليل والتبريك للأشخاص أكثر من التهليل والتبريك للأوطان؛ فهل أصبحت الأوطان درجة ثانية والزعماء هم الوطن بالنسبة للشعوب؟ قد يقول قائل، إن خرج البعض وشذّ عن هذه القاعدة، سيقتل أو يسجن. هذا صحيح، فسياسة القمع مرافقة وملازمة لـ “سياسة القطيع” وإلا ستنهار المنظومة التي خدرت الشعوب العربية عبر تعاقب أجيال كثيرة.
هذا الزعيم لم يأتِ لوحده، بل جاء عبر الشعب وبمباركة منه، ما يعني أنه شريك، بشكلٍ أو بآخر، في صناعة هذه الأنظمة الفاسدة، فيصبحون شركاء في صناعته والتبعية المطلقة له عبر الهتاف والتصفيق للزعيم الأوحد بعبارة قديمة – جديدة “عاش الزعيم” أو هتافات تحمل صبغة دينية.
هنا، دعونا نضيء قليلاً على بعض الأمثلة. في أي نظام وحزب حاكم في بلادنا العربية، سواء كان إسلامي أو علماني أو عسكري، يتغلغل الفساد فيها جميعاً، والأنكى أنه يتلطى خلف قيادة صاغت رموزها السياسات على قياس أطماعها وتبعيتها وولاءها. لا ضير بالنسبة لهم طالما أنهم يحافظون على كراسيهم ومناصبهم؛ في هذه الحالة، الفساد لا عنوان له، وهذا مربط الخيل، إذ علينا أن نتقبل ونرضى بذلك لا بل أكثر.
هنا، أتذكر عند فوز الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بالرئاسة وكم فرح العرب، حيث أُطلقوا عليه حينها لقب “أبو حسين رئيس أمريكا”، حينما ظنوا أنه بأصوله مسلمة سينقذ ما خرَّبه أسلافه دون أن يتبصر أحد منهم في مفهوم “الدولة العميقة” ومخططاتها تجاه تدمير الأمة العربية. ففي عهده، لوَّح بضرب دمشق، فلا نفعت أصوله المسلمة ولا علمانيته ولا لونه ولا شيء آخر.
الأمر نفسه بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إبان مشاركته الحرب إلى جانب سوريا، حيث خرجت عبارات شعبية مثل “أبو علي بوتين”. هي واضحة المعنى وإلى ماذا ترمز. فلنفكر قليلاً، هل جاءت روسيا أو دخلت أمريكا وإيران إلا وللجميع مصالحه وتحالفاته؟ إلى متى هذا “التصحُّر الفكري” لدى الشعوب؟ يتكلمون ولا يفعلون، لا بل يعيدون تدوير الزوايا دون الخروج من هذه الدائرة!
صنّاع الديكتاتوريات
لا يختلف أحد أن المجتمعات العربية منقسمة على نفسها، هؤلاء يهتفون للعلمانية، وهؤلاء لـ “علي” وهؤلاء للخلافة الإسلامية، وكم من رئيس حمل إسم زعيم ديني وآخر ثوري، وما شابه ذلك، إلى أن وصل البعض للقول إن بلاء الأمة بسبب “الإخوان المسلمين”، والبعض الآخر إلى “ولاية الفقيه”، والآخر إلى “البعثيين”، كرموز نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وحتى “الناصريين”. نلاحظ أن جميعهم لم يسلم من تحميله وزر ما يحدث، سواء كان ذلك صحيحاً أم لا. فلقد تعودت الشعوب العربية أن تلقي التهم بما يتناسب مع أهوائها لمجرد إختلاف النهج أو العقائد أو الميول السياسية. المشكلة قطعاً وبدون أدنى شك تكمن في الشخصية العربية “الإنهزامية” التي تعقد الآمال على شخص واحد، دون أن تعمل أو تحاول العمل على إيجاد منظومة حكم لا شخصية لتحكم. إن صاغ لها قانوناً لا يعجبها، ثارت وإنتفضت، وغضبت، وإن أعجبها سكتت ورضيت؛ في كلتا الحالتين، لم يكن لها خيار وقرار الرفض أو القبول. كم من مظاهرات شهدناها مؤخراً؟ ماذا حققت؟ الجواب هو “لا شيء على الإطلاق”، بل إن أوضاعها تردت أكثر من ذي قبل.
لقد تناسى العرب أنهم هم من صنعوا الديكتاتوريات السياسية والمذهبية والحزبية وإجتهدوا في صانعة وصياغة “الفساد العشائري”، فإلتفافنا حول هؤلاء إلتفافاً عشائرياً لأن طبيعة وتركيبة العرب، بمجملها، عشائرية صحراوية وبدوية أخذت طابعها الحالي، بين الأديان والسياسة وتكتلاتها ومجالس عسكرية وغير ذلك. من خلال ما سبق، نستنتج أن هذه العقلية تميل بطبيعتها إلى الحروب والإنتقام والتصفيات رغم مظلوميتها، فتلك الشخصية العربية تحمل كل التناقضات معاً.

ما نقصده هو أنه إذا كانت الرموز والحكام والساسة فاسدة وظهرت فئات تريد تغييرها، وتغيرت الأنظمة والأشخاص بالفعل، فإن هذا التبديل ليس إلا بالأسماء إذ يبقى الفساد متربعاً على عرش الأمة جمعاء. فهذه الرموز الجديدة، لن ترتدع أو تخاف من أن تلقى مصير من سبقها، بل على العكس، حيث يمثل الفساد “موروثاً” خالداً وكأنه هو الأساس لأي حكم أو واقع لن يتغير.
ثقافة مفقودة
إن المشكلة التي نعاني منها تكمن في غياب ثقافة المؤسسات، والعقلية المؤسساتية التي تعمل لصناعة الأوطان بدلاً من تكريس عشائر أو طوائف أو أحزاب معينة. إن العقلية مؤسساتية تستطيع أن تحاكم وتحاسب وتشير إلى الأخطاء بعدالة خالصة هذا إن لم نقضِ على الفساد ككل ولو تدريجياً. عندما نؤمن بأن هناك مؤسسات تربوية وحكومية وهناك تكريس لمبدأ “تداول” السلطة بشكل صحي وسليم، وديمقراطية حقيقية شفافة، وقانون ودستور (كالدستور الأمريكي الذي يحدد بقاء الرئيس نفسه ولايتين متتاليتين فقط)، حينها سنجد أن هناك محاسبة حقيقة، لأي مسؤول بل لأي رئيس؛ عند ذلك فقط، يمكن أن نقول بأننا قد أصبحنا ضمن مصافِ الدول المتقدمة، غير التابعة أو الخانعة أو المرتهنة لأحد.
تخدير الشعوب
كل منا يسمع ويشاهد زيارات على مستوى رئاسي أو وزاري، عربي – غربي أو عربي – عربي، وتوقيع إتفاقيات أمنية وثقافية وتجارية، ونتوقف عند الأخيرة. ليست كل البلاد العربية دول منتجة، بل مستهلكة لكل شيء، رغم أن بعضها يمتلك مقومات الإنتاج، من زراعة وصناعة ويد عاملة، لكن لا يوجد شيء منها على أرض الواقع. عند توقيع بروتوكول إتفاقيات تبادل تجاري يتبادر سؤال طبيعي إلى الذهن: ماذا ستصدر هذه الدول التي تعاني أصلاً من إقتصاد منهك؟ ومع ذلك، تسحب المليارات من خزائن الدول لصرفها على مشاريع إفتراضية، في معظمها. فماذا تجني الحكومات والمسؤولون الفاسدون من اي تطور إقتصادي صناعي أو زراعي أو تجاري، إلا صرف الأموال، وحرمان الشعوب من خيرات بلادها، ومشاركة الطامعين بإفقارها.
إذاً، قوة الدول هي بقوة إقتصادها. بالتالي، إن أي تطور في دولة ما دولة مرتبط بتحقيق العدالة وإحقاق الحق وهذا هو بالضبط ما نفتقر إليه. لا تكاد تخلو دولة عربية من هذا الأمر، خاصة عندما نرى الطاقات المهدورة، والشباب المتعلم والذي لا يملك فرصة عمل، فلهذا الأمر مفرزات إجتماعية تزيد الأوضاع تعقيداً وأبرزها “هجرة العقول” بحثاً عن تقديرها وإنصافها لكن الأهم هو البحث عن العمل الذي تفتقر إليه في بلادهما. للأسف، على هذه العقول موالاة الحكام، لا الكفاءة، للإستفادة من فرصة عمل تقيها شبح العوز. كيف لا وهناك مؤسسات في الدولة توالي أشخاصاً لا أوطاناً، كبعض الجيوش أو الفرق العسكرية قديمة أو حديثة العهد، في حين أن واجبها موالاة الوطن، أولاً وأخيراً، والتقيد بالدساتير والقوانين.
إذا أردنا علاج كل هذه القضايا، علينا أن نؤمن بالمؤسسات ونبني إقتصاداً قوياً حقيقياً منتجاً، فنأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وننهض بهذا الإقتصاد في كل الميادين والمجالات، ونصنع هويتنا العربية الحقيقية غير المرهونة لأحد، توالي الوطن وتخدم الشعب وتحقق العدالة الإجتماعية. لكن اليوم، تعتبر محاكمة رموز الفساد والديكتاتورية “كذباً” يروجه الإعلام “الرسمي” للدول التي تعمل على إنتهاك حقوق الإنسان والمواطن، فلقد دمرت كل ما هو جميل وأصيل ورأينا مفرزات ذلك بصورة تجار الحروب والمسؤولين السياسيين والإقتصاديين.
للعلم، إن لم يعالج الجميع هذه الظاهر فسنفقد كل معاني الإنسانية والشرعية، دولاً وأفراداً؛ بالتالي، علينا الخروج من العقلية العشائرية ونفعل المؤسسات التي تستطيع مكافحة الفساد والحد منه. إن التفكير العشائري المغلف بصبغات عدة، مذهبية أو حزبية وأحياناً من دون صبغة. ولكن، كيف يمكن لك أن تكرر الخطأ وأنت تعرفه؟ وتنادي بالإصلاح وأنت تقتله؟ وتطلي من الآخرين أن يرحموك وأنت من تصنع من الضعفاء سجانين لك؟!
وطنك بحاجة إليك لكنك تستهين بنفسك وبقدرتك على التغيير. متى ما تحررنا من الإنتماءات الداخلية والخارجية سننتصر بإذن الله، فـ “الدين لله والوطن للجميع”. يجب أن نرى الوعي الحقيقي من قبل الشعب العربي كله، وأن يتوحد الصوت، فلا تصنعوا طغاة جدد عليكم، كافحوا رموز الفساد والديكتاتورية، وطالبوا بما هو حق لكم. البداية هي الإيمان بدور المؤسسات التي تعتبر “المنقذ العابر” إلى بر الأمان في وجه الطغمة الفاسدة. تمسكوا بما هو حق لكم، تمسكوا بـ “العقد الإجتماعي”، كما قال الفيلسون جان جاك روسو، لأنه الوثيقة الحقيقية التي تقوي وعي الشعب العربي، ولنخرج منه بقوانين جديدة تحمينا. لو وجد معي شخص يشارك ويتبنى مداميك هذا المشروع لنخرج قوانيناً جديدة تحمي الشعوب، فسأكون أول من يُقدم على ذلك من أجل النهوض بأمتي وأبناءها.
أخيراً، يجب التنبه والحذر إلى كل الكلام الذي يُستخدم لدغدغة مشاعر الشعوب، بعضاً منه مغلف بغلاف طائفي، أو حزبي أو قومي أو شرقي أو غربي. تذكروا، لا يوجد نظام على الأرض يخلو من العيوب وأبرز الأمثلة على ذلك هي الولايات المتحدة، “أم الديمقراطية”. كلنا تباع حادثة قتل جورج فلويد مؤخراً، أفعال التعذيب الشنيعة في سجن “أبو غريب” العراقي وسجن قاعدة غوانتانامو. كل ذلك لا يعني أنني أستثي بلداً عربياً أو غربياً، مهما تلطى خلف دين أو حزب؛ فللجميع إنتهاكاته الخاصة بحق شعوبه من أعمال لا إنسانية، كالمقابر الجماعية عمليات الإخفاء القسري والتصفيات الجسدية، إذ أن لكل منهم ديكتاتوريته وأسلوبه القمعي، وإنتهاكاته بحق الإنسان. فلا يرمينَّ أحد الآخر بما لديه أصلاً.
*كاتب ومفكر كويتي.
مصدر الصور: العرب – الحرة.
موضوع ذا صلة: القطان: الأوطان أولاً ومن ثم السياسات الحاكمة